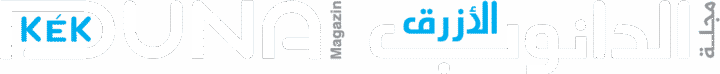ردّاً على سؤال حول المستقبل، طُرِحَ في إحدى محاضراته، قُبَيْلَ موته، أجاب ستيف جوبس قائلاً: «المستقبل؟ ليس موجوداً، علينا نحن البشر أن نبتكره». ستيف جوبس، مؤسِّس آبل، والذي يوصَف بأنّه واحدٌ من كبار الرّائين والخلّاقين المُجَدّدين في هذا العصر.يذكّرني هذا الجواب بجوابٍ لمتَصَوِّفٍ عربي لا نعرف اسمَه، قالَه منذ ألف سنة ردّاً أيضاً على سؤال: ما الزّمَن أو الوقت، قائلاً: «الزّمَن أو الوقت هو ما أنت فيه».
يجب إعادة النّظر، جذريّاً وعلى نَحْوٍ شامِلٍ، في المفهومات السّائدة عن الزّمَن إبداعاً وحضارةً، وعن العلاقات بين الأزمنة، ماضِياً وحاضِراً ومستقبلاً، وعلى الأخصّ عن العلاقات بين الزّمَن والإنسان، وعِبرها وفيها، بين الإنسان والإنسان.
حين ننظر الآن في لحظتنا الرّاهنة إلى الوضع الكونيّ، في مختلف تجلّياته السّياسيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة، وفي ضوء الجَوَابين السّابِقَيْن، ونسأل: ما هذا الزّمَن الذي يُهَيْمِن على العالم الذي نَنْتَمي إليه ونعيش فيه، فسوف نكون أمامَ جَوابَيْن أساسيّين: خلاصة الجواب الأوّل هي أنّ زمن الإنسان يتمَحْوَر حول الآلة، لا حول الإنسان. فهو زمنٌ انتُزِعَت منه خاصِّيتُه الإنسانيّة. والهاجِس الذي يملؤهُ ويُسَيِّره ويقوده لا يدور حول مستقبل الإنسان المُنْفَتِح، الحُرّ، الخلّاق، سيِّدِ نفسه وسيِّدِ مصيره، وإنّما يدور حولَ مستقبلِ الآلة وتقنياتها، وحول العبوديّة والهَيْمَنة. وسؤالُه الأساسي ليس «كيف أحرِّرُ العالم؟»، بل هو: «كيف أُخضِعُ العالم وأُنَوِّع سجونَه وقيودَها؟».
هكذا يكاد الإنسان أن يصبحَ شيئاً بين الأشياء. يكاد أن يُصْنَعَ كما يُصنَع أيُّ شيء. بل أكاد أن أقول: يُصْنَعُ كمثل الرّغيف ــ يُعجَن، ويُخَمَّر، ويُخبَز، ويُقَسّمُ ويوضَع على المائدة في ولائم مُتنوِّعة، فقيرة، غنيّة، بين بين ــ ولائم، على مستوى الكون ــ سلاماً وحرباً، ثقافةً وسياسةً، اجتماعاً واقتصاداً، فنّاً وفكراً وعلماً.
باسم الحاضر والدّفاع عن حقوق الإنسان، يُلغى الإنسان نفسُه، في تنويعاتٍ إباديّة قلّما عرف التّاريخُ تَوَحُّشاً يُضاهيها.
وباسم المستقبل، ها نحن ندخل في حضارة ما بعد الإنسان، بعد أن تخطّانا الزّمن الذي أسّس لثقافة الآلة، أو ما بعد الإنسان.
وخلاصةُ الجواب الثّاني هي أنّ العالم يعيش في أزمنةٍ ثلاثة: زمن ما يُسَمّى، عمليّاً، «العالم الأوّل»، وزمن ما يُسمّى عمليّاً «العالم الثّالث» و«الزّمن الآخر» الذي يتراوح بينهما هبوطاً صعوداً، جَزراً ومَدّاً.
لكن، إذا نظرنا إلى هذا العالم الثّالث، بوصفه أفراداً، في مَعزِلٍ عن الأنظمة والجماعات والمؤسَّسات، فسوف نجد أنّ الفرد في العالم الأوّل ليس في حَدّ ذاته، وبوصفه فرداً، أكثر ذكاءً أو قدرةً على الإبداع من الفرد في العالم الثّالث. ليس دانتي، على سبيل المثال، بوصفه فرداً، أعمق إبداعاً وأعظمَ إنسانيّةً من أبي العلاء المعرّي. وليس ديكارت أكثر فهماً للعالم والإنسان من ابن رشد أو من ابن الرّاوندي، وليس بودلير أكثر شعريّةً من أبي نواس. وليس مالارميه أعمق أو أعلى جماليةً من أبي تَمّام.
هكذا، وفي هذا تحديداً، تكمن، بالنّسبة إليّ، أهميّة البحث في مشكلةٍ أعِدُّها شخصيّاً جوهر مشكلاتنا كلّها، حياةً، ومَصيراً. ومَدارُ هذه المشكلة هو أنّ الزّمنَ في أبعاده التّكوينية، لا يُبحَثُ تجريديّاً في ذاته ولذاته، كما تُبحَثُ النّظريّات في المُختَبرات، في مَعزِلٍ عن رياح الحياةِ وأعاصيرها، عن غبارها وجنّاتها وينابيعها. لا يُبحَثُ الزّمنُ في معناه، إنسانيّاً، إلّا وهو بين يدَي الإنسان، في بيته، في سرير نَومه، في حِلِّهِ وترحاله، في خطواته إلى عمله، في عمله ذاتِه، وفي قلبه وعقله، إضافةً إلى فرحه وحزنه، إلى فكره ودفاتره، وكتابته، إلى مُخَيّلته وأحلامه.
إنّه الحبُّ والكراهية، الجمال والقبحُ والإبداع، الخير والشرّ، الشّعر والرّسمُ، الموسيقى والغناء، الفلسفة والعلم، إنه الكتابُ واللوحة والقصيدة، الماءُ والخبز.
نعم الزّمنُ ابتكارٌ: و«الزّمنُ هو ما أنتَ فيه»، جسدٌ آخر، داخِلَ جسدِ الإنسان. تارةً يبدو كمثل غيمةٍ، شباباً أو شيخوخةً، وتارةً كمثل لجّةٍ، علُوّاً واقتحاماً، وطوراً كمثل زلزالٍ، وأحياناً كمثل كرةٍ بين يَدَيْ طفلٍ، وقبل كلّ شيء ليس الزّمَنُ آلةً، وليس هو مَن يخلق الإنسان، بل الإنسان هو الذي يبتكره، ثانيةً ثانية، دقيقةً دقيقة، ساعةً ساعة، يوماً يوماً.
كيف حدث، إذاً، أنّ الزّمنَ الذي نعيش فيه أو يُفرَضُ علينا، باسم الحداثة والتّقَدُّم، أو باسم «العالم الأوّل»، كيف حدث أن يستعبدَنا، وأن ترتبط به حياتنا ارتباطاً يكاد أن يكونَ في مستوى الوجود ذاته؟
كيف حدث أن يَسْتَعْبِدَ الزّمن الإنسانَ بدلاً من أن يحرّره؟
إنّه زمنُ الآلة! إنّها الآلة. آلةُ الاستعباد، سياسيّاً واقتصاديّاً. لكن يظلُّ السّؤالُ مُلِحّاً : كيف أمكن أن يصبحَ الإنسان، مبدعَ الآلة وسيِّدَها، تابعاً لها، ولماذا؟
كيف أمكن أن يُنظَرَ إلى الآلة، كأنّها الأكثرُ ذكاءً وتعقُّلاً من الإنسان نفسه؟ وكيف حلَّ زمنُ الآلة الذي يبشِّرنا بالإبادة المُتَواصِلة وبالمَوت اللامتناهي، محلَّ زمن الطّبيعة زمن الحياة اللامتناهية، زمن الحبّ والشّعر، زمن الصّداقة والحرّيّة والإبداع.
وعلينا جميعاً أن نلاحظَ أنّ زمنَ الآلة يزداد شراسةً في تطويق الإنسان بكلّ ما يهدِّد وجوده على هذا الكَوكب البديع، الأرض الأمّ. ولا ينحصر هذا التّهديد في البيئة والمناخ، وتدمير البشر ومُنجَزاتهم الحضارية الفريدة، والهجرات، فرديّةً وجماعيّة، وطوفان البحار والمُحيطات، حيث تغرق المدنُ، ويتناقَصُ الغِذاءُ ويسود الجفاف،وتنقرض الأنواع، وإنّما يتخطّى ذلك إلى الوبأ التّدميريّ الشّامل، بأشكاله العدة المُختلفة التي يبتدعُها البشَرُ أنفسهم، أولئك الإرهابيّون، المُجَنَّدون على المستوى الكَوْنيّ، أنظمةً وجنوداً، أسلحةً وحروباً.
هكذا يبشّرنا زمنُ الآلة أنّنا سندخل في زمن ما بعد الإنسان، زمن الروبوتات، نقيضاً كاملاً لزمن الطّبيعة والإنسان نفسه، ونقيضاً كاملاً لأمِّنا الأرض، وطن الإنسان وأصل الحياة.
وهكذا نصل إلى الحياة في ثقافةٍ تواجِه الحاضِرَ بالغائب، وتطرح الأسئلة على الماضي، لكي يرسم لها صورة المُستقبل.
كم هو الزّمنُ إذاً، بخاصّةٍ في صيغة المستقبل، غامض، خطِرٌ، مُرعِبٌ. كم هو كذلك حتّى أمام أعيُننا وبين أيدينا. لكأنّه يبدو لي شخصيّاً، مُجَسَّداً في مُجَمَّعٍ آليّ ضخمٍ يتمدَّدُ مُتَشَعِّباً إلى ما لا نهاية، في الاتّجاهات كلّها، ناشِراً السّمومَ والكَوارثَ في هذا الهواء الكَونيّ الطّلْق.
لكن يبقى في جحيم هذا كلّه، وضدّ هذا كلّه، زمنٌ آخر هو زمن الطّبيعة، زمن الإنسان ــ الطّبيعة، زمنُ الإنسان ــ عقلاً وجسداً وطاقاتٍ خلّاقة.
وها نحن جميعاً، نجيء من أمكنةٍ مختلفة، ويجمعنا معاً على تباعدها وتَبايُنِها مكانٌ واحد، ونشترك ثقافيّاً وعلميّاً في قضايا ثقافيّة واحدة، لكنّنا في الوقت نفسه نختلف على أكثر من صعيد. وتتبايَن آراؤنا في معنى الحبّ والشّعر والجمال والحريّة والصّداقة، وغيرها. ذلك أنّ هذه كلّها لا تجيء من المُشتَرَك العامّ أولا تجيء من الآلة وثقافتها، وإنّما تجيء من الطّبيعة، من الفرادة الخاصّة بكلّ شخصٍ منّا. فمن المستحيل أن يحلم الإنسان الحلمَ نفسه الذي يحلم به الآخرُ القريب ولو كان أخاه أو أمّه أو أباه. فكيف يمكن إذاً أن يحلم حلمَ الآخر البعيد؟
هكذا يستحيل على البشر أن يعيشوا جميعاً في زمنٍ واحد، إلّا شكليّاً، وبالدّلالة التّجريديّة المَحضة، وفي هذا سرُّ فرادتهم وهويّاتهم.
فلكلٍّ منّا زمنُه الخاصّ، داخلَ الزّمن العامّ الشّامل. والأشياءُ هي وحدها تتساوى أزمنةً وأمكنة.
اسمحوا لي أن أذكر اسمَ عربيٍّ آخر هو الفيلسوف الفارابي، وأن أنقل إليكم عبارة فريدة وعالية في هذا الإطار الذي نتحدّث عنه. تقول العبارة: «كلُّ مَوجودٍ في ذاتهِ فذاتُهُ له. وكلُّ مَوجودٍ في آلةٍ فذاتُه لغيره».
وسؤال الإنسان عن الزّمن في ضوء هذه الكلمة، يبدأ بسؤال الإنسان عن نفسه:
«هل أنا موجودٌ في ذاتي وكيف، ولماذا؟». وما هذه الآلة التي تنفيني، أو تحوّلني أنا نفسي إلى آلة؟ ذلك أنّ البحث في مسألة الزّمن، هو بحثٌ في الكينونة، وبحثٌ في الهويّة ومعناها.
وسؤالي أنا شخصيّاً، بوصفي عربيّاً، هو: هل أحيا وأفكّر وأكتب وأعمل في زمنٍ يمكن أن أسمّيه، إبداعيّاً، زمناً عربيّاً، علماً وفنّاً وفلسفةً واقتصاداً وسياسةً، سيادةً وإرادةً، أم أنّني، على العكس، أحيا في زمن الآخرين؟ لكن عليّ أن أسأل: كيف؟ ولماذا؟
التَّبَعيّة لزمن الآخرين تعني أنّ الذّات لا هويّة لها ولا سيادة لها حتّى على نفسها، ومَن لا سيادة له، لا إرادة له. يكون مجرّدَ أداةٍ لآخرين يصنعون بها أزمنتهم ويفرضونها ويُعَمِّمونها بطريقة أو بأخرى، قليلاً أو كثيراً، وذلك هو الاستعمار الاستعباديّ في أعلى أشكاله.
لكن، انطلاقاً من هذه الذاتيّة التي هي جوهر الإنسان، واستناداً إليها، يمكن القول إنّ زمنَ الآلة، مهما كان طاغِياً، عاجزٌ عن استئصال الإنسانِ من الطّبيعة، في صورتها العُليا.
زمنُ الذّات وزمنُ الآخر. وهو زمنٌ ليس آلةً، ليسَ برميلاً يتدحرجُ فيه الإنسان. لا زمنَ لمن يعيش ويفكّر ويعمل تابعاً لزمن الآخرين. لا زمنَ لمن لا يبتكر زمنَه…
يستحيل أن يكون للآلة رَحِمٌ وطفلٌ ورضاع. يستحيل أن تعشق أو تحبّ أو تُصادِق أو تُبدِع، أو تحلم. يستحيل عليها قبل كلّ شيء، أن تفعل أيّ شيء إلا بإشراف الإنسان وتَعليمه وقيادته. والعِلّةُ، إذاً، ليست في الآلة نفسها، أو في زمنها، وإنّما العلّةُ في العَقْل الذي يستخدمها، العلّةُ في الإنسان نفسه.
ولَئِن كان الوجودُ سؤالاً يتجدَّد باستمرار، وينتظِر جواباً يتجَدَّد، هو أيضاً باستمرار، فإنّ قوّةَ الإنسان الأولى لا تكمن في الأجوبة، مهما عَلَت، وإنّما تكمن على العكس في الأسئلة. ويستحيل على الآلة أن تطرح بذاتها وبلسانها وشفتيها، في مَعزِلٍ عن سيادة الإنسان وإرادته، أيّ سؤالٍ، لا على الوجود ولا على نفسها.
بعبارةٍ موجزة: الإنسان مُبدِعُ الآلة، والإنسان سيِّدُها. والعلّةُ، مرّةً ثانية، هي في هذا الإنسان نفسه.
أصِلُ إلى الخلاصة التّالية:
مهما تغيَّرت الأزمنة أو تعدَّدَت، يبقى زمنان رئيسيان:
زمنُ الذّات وزمنُ الآخر. وهو زمنٌ ليس آلةً، ليس برميلاً يتدحرجُ فيه الإنسان، وليس ظِلاً يأوي إليه، وليس أدواتٍ يستعيرها، وليس لباساً يتزيّا به. إنّه بالأحرى قلبٌ آخر يحيط بقلب الإنسان، وينبوعُ حياةٍ يتدفّق داخِلاً، إلى الذّات، خارجاً منها إلى ما حولها.
الإنسان، بتعبير آخر هو الزّمن، وفيه تتلاقى لحظات الحريّة ولحظات الإبداع، لحظاتُ الانعتاق ممّا انتهى، والانخراطِ في اللحظات التي تُبدِع ما يأتي، حيث يحيا الإنسان طبيعته الخلّاقة، حلماً وعملاً، ذاتاً وآخر.
وزمنُ الإنسان، إمّا أن يكونَ حرّيّةً أولى وابتكاراً متواصِلاً، وإمّا أن يكون قيداً وسجناً. ذلك هو المفتاح الأساسيّ لعلاقة الإنسان بنفسه، ولعلاقته بالإنسان الآخر، ولعلاقته بالعالم. وهو نفسه مفتاحٌ لأبواب الزّمن ومعناه.
بلى، لا زمنَ لمن يعيش ويفكّر ويعمل تابعاً لزمن الآخرين.
لا زمنَ لمن لا يبتكر زمنَه.
قل لي ما زمنكَ، وسوف أقول لك ما مكانُكَ ومَن أَنت!
أدونيس – الأخبار اللبنانية – آذار 2024